يبدو أن المناظرة التي جمعت بين الأستاذ أحمد عصيد والدكتور طلال لحلو، أخذت أبعادا أخرى بعيدة عن جوهر وأهداف المناظرة.
حين نتحدث عن مناظرة، فإننا أولا نتحدث عن رأيين مختلفين، وأطروحتين متمايزتين. أي مناظرة كيفما كانت، لا يخرج الهدف منها عن أمرين اثنين: محاولة التقريب بين وجهتي نظر المتناظرَيْن، وإقناع كل متناظر لغالبية الجمهور بوجهة نظره.
لكن مناظرة عصيد ولحلو، لم تتجه في اتجاه تقريب وجهتي النظر، لأن كل واحد بقي متشبثا برأيه ومدافعا عن أطروحته حتى أخر كلمة في اللقاء. أما الجمهور فيبدو أن طلال لحلو عرف كيف يُقنع غالبية الجمهور الذي وجد فيه صوته، ولغته، وأسلوبه، عكس عصيد الذي وجد صعوبة سواء في الدفاع عن أطروحته أو في تفنيد أطروحة خصمه في الفكر بطبيعة الحال.
لسنا في حاجة لاستطلاع رأي الجمهور حول المناظرة، لمعرفة خلاصات مواجهة عصيد ولحلو. يكفي مواكبة تبعات المناظرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتبين لنا بكل جلاء أن طلال لحلو كان أكثر إقناعا من أحمد عصيد. وما يؤكد هذه الخلاصة، الخرجات المتتالية لمناصري أطروحة عصيد، يحاولون الدفاع عنه باستماتة وبطريقة توضح أن عصيد، لم يكن مُقنعا لعموم الجمهور الذي تابع المناظرة.
ما عرفته المناظرة من تبعات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، أخرجتها من الأهداف التي تميز عادة مثل هذه المناظرات. ففي الوقت الذي يكون فيه الهدف من النقاش هو تقريب وجهات النظر، وخلق توافق مجتمعي حول قضاياه المصيرية في بعض الأحيان، نجد أن مناظرة عصيد ولحلو، كرَّست الفُرقة، وزادت من حدة التباعد حول أطروحتين تشغلان الرأي العام في المجتمع. أطروحة متمسكة بالمرجعية الإسلامية ومنفتحة على الحداثة، وأطروحة علمانية تتبنى الحداثة الفرنسية.
سيحاول هذا المقال طرح النقاش حول مناظرة عصيد ولحلو من باب الهدف الرئيسي لأي مناظرة، وهو إقناع الجمهور وتقريب المواقف. النقاط التالية تعرض لأهم عناصر النقاش من أجل تبليغ الأفكار بيسر وسلاسة:
أولا: المناظرة في حد ذاتها، إنجاز فكري ومجتمعي وجب التنويه به. فالمجتمعات تتقدم بالنقاش، وتتطور بطرح الأفكار للنقد والتمحيص. فلا أحد يمكنه الادعاء بامتلاك الحقيقة كاملة. وما تفاعل الجمهور مع هذه المناظرة بهذا الزخم، إلا دليل على تعطش المجتمع للنقاش والحوار الهادئ. كما أن المناظرة تمت بشكل هادئ ورصين من الجانبين، وهذا هو الحوار المطلوب في مجتمعنا.
ثانيا: لفهم الأطروحات التي راجت خلال المناظرة، يجب وضعها في سياقها التاريخي. فبعد الاستقلال، ظهر في المجتمع المغربي، توجهان فكريان رئيسيان. توجه يساري كان حينها متأثر بالأيديولوجية الماركسية ويؤمن بالحزب الوحيد والفكر الوحيد. وتوجه إسلامي يؤمن بالخلافة ويعتبر نفسه على صواب والآخر على ضلال. وكان كل توجه فكري لا يؤمن بالنقاش، بل يحاول إلغاء الآخر.
ثالثا: دائما في السياق التاريخي، شهد المغرب صراعا محتدما بين التيار اليساري والتيار الإسلامي. هذا الصراع كان من بين نتائجه الإيجابية، تطور الفكرين معا. التيار اليساري، تخلى عن فكرة الحزب الوحيد، ولم يعد يردد مقولة “الدين أفيون الشعوب”. أصبح يؤمن بثوابت الأمة وعلى رأسها الإسلام كدين المغاربة وليس دين خصمه التيار الإسلامي فحسب. كما أن هذا التيار عرف تطورا أخر، جعله يؤمن بالتيار الإسلامي ويتعامل معه في المشترك بينهما. ويؤمن بالعلمانية التي ليست ضد الدين، إلى جانب قِيَّم الحداثة.
التيار الإسلامي هو الآخر، عرف العديد من التطورات وتخلى على العديد من الأفكار. لم يعد يؤمن بالخلافة، ويتبنى أطروحة الدولة المدنية، وأصبح متمسكا بثوابت الأمة. كما أنه أضحى يؤمن بالخلاف وبحق الآخر في التواجد والتعبير عن رأيه. تَطَوَّر مجددا فكر التيار الإسلامي وصار يبحث عن نقاط الالتقاء مع التيار اليساري مادام هذا الأخير يؤمن بالثابت الديني للمغاربة. أصبح كذلك تيارا يقترب من قيم الحداثة ويبحث عن نقطة التوازن بين الحداثة والضروريات الدينية.
رابعا: التطور الذي عرفه كل من الفكر اليساري والفكر الإسلامي في بلدنا، ساهم في خلق نقاش مجتمعي. هذا النقاش وضع كل أطروحة على محك الواقع والممارسة المجتمعية، وهو ما ساهم بشكل كبير في تطوير النقاش المجتمعي من أجل التقريب بين الأطروحتين، وتجنيب المجتمع الانقسام السلبي بين توجهين متصارعين في غياب أي نقاش أو حوار. ومناظرة عصيد ولحلو، ليست إلا أحد تجليات هذا التطور الذي عرفه الفكر اليساري والفكر الإسلامي في بلدنا، وهو عامل إيجابي ومفيد وجب تشجيعه والتمسك به.
خامسا: إذا كانت المناظرة إيجابية ومفيدة، واتسمت بالنقاش الهادئ من الجانبين، فإن النقاش الذي خلفته لم يكن لا صحيا ولا مفيدا. كنا ننتظر من المناظرة أن تخلق نقاشا مجتمعيا، يساهم في تقريب الآراء والقناعات، لكننا وجدنا البعض يطرحها في سياق المنتصر والمنهزم. حتى أن البعض ممن يدور في فلك التيار العلماني، يدعو إلى عدم القيام بهذه المناظرات، وكأنه أصبح لا يؤمن بالحوار. ولا نعلم ما الذي يقترح هذا الطرح خارج دائرة الحوار والتقريب بين الأفكار.
وإذا استحضرنا النقاش الذي واكب المناظرة في وسائل التواصل الاجتماعي، فإننا نقر بضرورة تطوير تفاعلنا الاجتماعي والفكري مع مثل هذه المناظرات. قوة لحلو في الإقناع لا يعني الانتصار، وضعف عصيد في الاقناع لا يعني الانهزام. ليس هذا هو الهدف المتوخى من المناظرة.
قوة حجج لحلو وثقافته الواسعة في العلوم والأبحاث، واستشهاده بمقولات فلسفية تمتح من علماء الاجتماع من داخل المنظومة الغربية، كان يجب أن يوضع في إطاره الصحيح. وإطاره الموضوعي هو أن يبتعد التيار العلماني عن تصوره النمطي للتيار الإسلامي، كتيار يعادي الفلسفة ويبتعد عن النظريات الغربية في علوم الاجتماع. وهو تصور يعود لسبعينيات القرن الماضي حين كان الفكر اليساري هو أيضا يؤمن بالحزب الوحيد ويلغي حق المخالف في الوجود وحتى في التعبير.
سادسا: يجب الانتباه إلى أن المناظرة جمعت بين جيلين: جيل يسار سبعينيات القرن الماضي الذي يمثله عصيد. وجيل الشباب الحالي، الذي يمثله طلال لحلو. وكما يقال لكل جيل ثقافته وميولاته، وهو ما اتضح جليا في المناظرة. عصيد كان في هذه المناظرة، يمثل الجيل الماضي، ويستعمل ثقافة كانت سائدة يوما ما، ومسيطرة على جيل تلك الفترة الماضية. فيما طلال لحلو يمثل الجيل الحالي، الجيل الرقمي، أسلوبا ولغة واهتماما وثقافة وطريقةً في التفكير.
قوة طلال لحلو في الإقناع حقيقة لا تخطئها عين، ساعده في ذلك انتمائه للجيل الحالي بثقافته وموسوعيته واهتماماته الفكرية، إنه جيل التواصل الاجتماعي والكم الهائل في المعلومات. لذلك نجد نتائج المناظرة تسير في اتجاه أطروحة طلال لحلو، شكل تمكنه من اللغات خاصة الفرنسية والانجليزية قوة إضافية، وهي ميزة يتسم بها الجيل الحالي الذي يعيش في مجتمع منفتح، مكنه من التضلع في اللغات الأجنبية.
أحمد عصيد ظل وفيا لمنهاج جيل سبعينيات القرن الماضي بأطروحاته وأفكاره. وهو ما لم يجد فيه الجيل الحالي ذاته وميولاته العصرية. كما أن اللغة لم تساعد عصيد في إقناع الجيل الحالي المتمكن من اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية.
لقد بدا واضحا في المناظرة، أن طلال لحلو تَمكَّن من مخاطبة الجيل الجديد بلغته ومفاتيحه المعرفية، في حين بقي عصيد وفيا لمنهج جيله، وهو ما عمّق الفجوة في التفاعل الجماهيري.
سابعا: نقول في الختام إن المناظرة لا ينبغي أن تخضع لمقياس المنتصر والمنهزم، ولا لمعيار الرابح والخاسر. بل يجب أن ننوه بالمتناظرين اللذان قدما صورة حضارية في النقاش، وهو ما يجب أن يسود في المجتمع. كما أنهما انخرطا في إعطاء الحق للآخر في إبداء رأيه بعيدا عن منطق أنا أمثل الحقيقة والآخر يمثل الخطأ. وأخيرا الهدوء الذي ساد المناظرة رغم قوة الخلاف في الأطروحات، يشكل قوة المناظرة، ويجب أن نعمل على تعميمه على جميع نقاشاتنا المجتمعية.
إن مناظرة عصيد ولحلو، رغم كل ما أثارته من جدل، كانت تمريناً ديمقراطياً نادراً في فضائنا الثقافي، وفرصة لقياس تطور الفكر والمجتمع معا. ولعل أبرز ما نخرج به من هذه المناظرة، ليس انتصار طرف على آخر، بل الانتصار لثقافة الحوار، والحق في الاختلاف، والحاجة المستمرة إلى منابر تعيد للفكر هيبته في زمن الضجيج.
فلا نريدها مناظرة تفتح الجدل وتُغلق الحوار، لكي لا تكون مناظرة فاشلة. نريدها مناظرة تُقنع الجمهور وتُقرِّب بين الأطروحات، وليس مناظرة تُكرس الفُرقة وتُعمق الصراع.
سعيد الغماز-كاتب وباحث

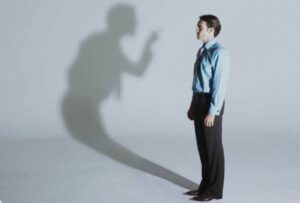

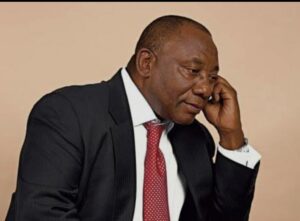

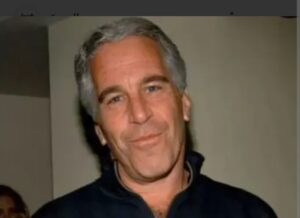
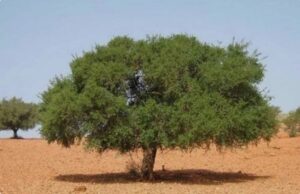
التعاليق (0)