يبدو أن الأستاذ أحمد عصيد لم يقم بتقييم المناظرة التي جمعته مع الدكتور طلال لحلو. المتعارف عليه في العالم المتقدم، أن الفكر التقدمي ليس جامدا، بل هو فكر يرتكز على النقد كوسيلة لكي يتطور ويتقدم. فهل قام عصيد التنويري بنقد ذاتي بعد المناظرة، كما هو حال الثقافة التنويرية في بلدانها؟ أم أن عصيد الأدبي، لا يقبل النقد، ويمتلك
الحقيقة، كما هو شأن الثقافة السائدة في العالم الثالث؟
من أهم الخلاصات التي أفرزتها مناظرة عصيد ولحلو، ثلاث ملاحظات:
أولا: أبرزت المناظرة أن عصيد يُنتج أفكارا من وحي خيال عقله، دون التثبت منها، أو تبريرها بدراسات أكاديمية ونظريات علمية. استناد طلال لحلو إلى الدراسات الميدانية والحجج العقلانية بمنهج علمي، أبرز أفكار عصيد كثقافة عارية، تحتاج لملابس فلسفة العصر التنويري، كي تكون صادرة من عقل يمتلك آليات التفكير العقلاني. إنها مناظرة جمعت بين عقلي أدبي يمتح من السرد الروائي، وعقل علمي يمتح من المنهج العقلاني.
ثانيا: يعتبر عصيد أن العالم الغربي المتقدم، هو النموذج الذي يجب أن نتبعه لتحقيق التقدم المنشود. وقوانين الغرب تسمو عن قوانين المغرب وثقافة المغاربة. لكن عصيد ظهر أمام طلال لحلو، لا يعرف جيدا هذا الغرب الذي يتحدث عنه، ومعلوماته عنه تبقى سطحية، قياسا للفهم العميق الذي برز به طلال لحلو، لأفكار وقِيَّم هذا الغرب. فأفرزت المناظرة، خلاصة متناقضة: لحلو المتضلع بعمق الثقافة الغربية، يتوجس من اتباع منهجها في كل شيء. مقابل عصيد الذي يفهم الثقافة الغربية بشكل سطحي، وينادي باتباع الغرب في كل شيء، لأنه هو طريق التقدم.
ثالثا: أمام طلال لحلو المتمكن جيدا من لغة موليير، ظهر عصيد بلغة فرنسية ضعيفة لا تمكنه من فهم ثقافة العالم الغربي المتقدم. وهي مفارقة تطرح أكثر من سؤال حول نجاعة الأفكار التي يدعو إليها عصيد.
بعد المناظرة مع طلال لحلو، خرج الأستاذ عصيد بشريط جديد، يطرح فيه سؤال: “هل أخذ الغرب علومه من المسلمين؟!” مذيلا تساؤله بعلامة تعجب لا موقع لها في سؤال يجب أن يتذيل بعلامة استفهام فقط كما يفعل التنويريون في العالم الغربي المتقدم.
وكما كان حاله في المناظرة مع طلال لحلو، قدم جوابا استباقيا دون برهان عقلي ولا تحليل علمي حيث قال “هاد الفكرة فيها واحد الجانب صحيح، وفيها بزاف ديال الغلط” بتفخيم الزاي في “بزاف”، مضيفا “لأنه كيكرس التخلف ديالنا، وكيجعلنا بعاد على الواقع، وكيمنعنا من أننا نكتاسبو الأسباب الحقيقية ديال التقدم في العصر لي حنا فيه، هادشي علاش ما أدات شاي الفكرة لي كانقولوها، لواحد النهضة ديال العلوم فهاد البلدان، بقدرما ضاعفات من اتشار مظاهر ديال التدين الخارجية، مصحوبة بالكثير من الأفكار الخرافية واللاعقلانية، بلا ما نهضروا على الأفكار السياسية لي كاتكرس الاستبداد الثيوقراطي”.
ربما هكذا يفهم العقل الأدبي لعصيد المنهاج العلمي. أو لنقل إن الأمر متعلق بالحالة النفسية لعصيد بعد تبعات المناظرة مع طلال لحلو، وما أبرزته من حقائق كان عصيد لا يريد أن تظهر للمتابعين. لذلك نجد شريطه الذي يتحدث فيه عن العلوم، مشحون بمصطلحات قدحية تمتح من ثقافة الجاحظ الذي هجا قُبح وجهه. هذا الشريط تحدث عن كل شيء، إلا المعرفة العلمية والطرح العقلاني الضرورية في موضوع يتناول العلوم الدقيقة.
من بين ما تميز به عقل العصر التنويري الذي شهدته أوروبا، هو احترام التخصص. بل في هذه الحقبة من تاريخ الغرب، عرفت العلوم تطورا كبيرا وتوسعت في التخصصات. فأصبح التخصص في الفيزياء مثلا، لا معنى له بعد ظهور علوم دقيقة في الفيزياء، لا يتقنها إلا من تخصص فيها. فأصبحت التخصصات في الفيزياء موزعة بين الفيزياء الصلبة والفيزياء الفلكية ونانو فيزياء وغيرها من التخصصات.
هذا في الثقافة التنويرية التي تقدم بها الغرب. أما في ثقافة بعض من يصفون أنفسهم بالتنويريين في المغرب، فإن “التنوير” له خصوصيات أخرى بعيدة عن التنوير في العالم الغربي، وقريبة من ثقافة العالم الثالث. فبعد الدكتور الفايد الذي يفهم في الرياضيات والفيزياء والطبيعيات والفلسفة والعلوم الشرعية والتغذية. بل يفهم حتى في الذكاء الاصطناعي، وبإمكانه صناعة لقاح ضد فيروس كورونا، ظهر الأستاذ عصيد يتحدث عن تاريخ العلوم في العصر الإسلامي، دون عناء البحث في موضوع بعيد عنه، لأن العقل الأدبي ليس كالعقل الدارس للعلوم الدقيقة.
إن هذا المشهد يرجع بعقل هؤلاء التنويريون في المغرب، إلى أربعة قرون قبل الميلاد، حين كان المثقف فيلسوفا وطبيبا وفلكيا ورياضيا وفيزيائيا. آنذاك كان هذا الجمع بين مختلف العلوم طبيعيا، لأن تلك العلوم لم تتطور كما هو حالها في عصرنا الحالي. فهل هذا تنوير أم تقليد لعلوم تعود لفترة ما قبل الميلاد؟! وعلامة التعجب بعد علامة الاستفهام تكون منطقية في هذه الحالة.
لو قام الأستاذ عصيد ببحث صغير عن تاريخ العلوم، ولو استعان بمتخصص في أحد العلوم الدقيقة، لأدرك أن ما قاله في شريطه، بعيد عن العلم والفكر العقلاني.
العلوم الدقيقة لا يمكن حصرها في حقبة زمنية واحدة، ولا نسبها لأمة أو حضارة واحدة. العلوم الدقيقة هي نتاج إبداع بشري وعطاء إنساني على مرِّ الحقب والعصور. فمنذ اختراع الكتابة في عهد السوماريين، عرفت العلوم تطورات ساهم فيها المصريون القدامى والهنود والصينيون والأشوريون.
ثم تطورت العلوم أكثر في حقبة اليونان، وبعدهم أخذ مشعل تطوير العلوم العصر الإسلامي الذي عرف فيه العلم طفرة كبرى، ليتسلم مشعل التطوير العالم الغربي الذي أوصل العلوم إلى حقبة الرقمنة والذكاء الاصطناعي. هكذا هو تاريخ تطور العلوم الذي لم تفهمه ثقافة عصيد.
ما لا يمكن أن يفهمه العقل الأدبي للأستاذ عصيد، هو أن العلوم الدقيقة في الحقبة الإسلامية، عرفت تطورا كبيرا فاق بكثير التطور الذي عرفته العلوم في العصر اليوناني. دون أن ننكر دور علوم هذا العصر في ذلك، وهنا أشير إلى دار الحكمة في عهد المأمون، التي جعلت العقل العلمي الإسلامي يتطلع إلى علوم الإغريق.
لإبراز هذه الحقيقة العلمية، سأسافر بعقل عصيد الأدبي، إلى عالم العلوم. ودون الخوض في التفاصيل العلمية الدقيقة، أكتفي بثلاثة نماذج فقط. وهنا سأتحدث بلغة العلم وليس بلغة السرد الأدبي.
أولا: ربما العقل الأدبي للأستاذ عصيد يعرف جيدا أن الخوارزمي هو أول من اخترع رقم الصفر. لكنه لا يعرف أن الخوارزمي ساهم في إعطاء نظريات لحل المعادلات من الدرجة الثانية والثالثة، وهو ما عرضه في كتابه الشهير “المختصر في حساب الجبر والمقابلة”. هذه لن يفهمها إلى المتخصص في الرياضيات كما يقول ويكرر الدكتور الفايد.
كما أن عقل عصيد الأدبي لا يمكنه معرفة أن الخوارزميات التي كانت وراء ظهور أول كومبيوتر، وصولا إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي، كان ورائها رقم الصفر الذي ابتكره العالِم الإسلامي محمد بن موسى الخوارزمي. وبذلك لُقِّب الخوارزمي بأنه أبو الحاسوب لدوره الكبير في الحواسيب، من خلال الخوارزميات. جميع البرامج التي تَستعمِل الخوارزميات تتحدث لغة ثنائية هي صفر وواحد، وهي العمود الفقري للعالَم الرقمي الذي نعيش أطواره حاليا. أقف عند هذا الحد لأن الأمر له تخصص يتطلب عقلا علميا خالصا، بعيدا عن العقل الأدبي للأستاذ عصيد.
ثانيا: لو قام عصيد ببحث بسيط باستعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لعرف أن أبو القاسم الزهراوي أخذ علم الطب عن اليونان خاصة أبقراط وجالينوس وأسقليبيوس وديوقليس، وقام بتطوير علم الجراحة بشكل غير مسبوق خلال جميع الفترات الماضية. وهو ما يفسر اعتماد العالم الغربي على كتاب الزهراوي في الطب “التصريف لمن عجِز عن التأليف” لمدة تزيد عن 500 عام إلى جانب كتاب ابن سينا “القانون في الطب”.
المقالة الأخيرة في كتاب الزهراوي هي سبب شهرته وهي من أكسبته لقب “أبو الجراحِين”. هذه المقالة خصصها الزهراوي للحديث بتفصيل عن الجراحة وسماها “في العمل باليد”. وبذلك يكون الزهراوي أول من أدخل الجراحة كتخصص تابع للطب.
نعم … لم يستطع الطب في أوروبا تجاوز العلم الذي خلفه الزهراوي إلا بعد مرور أكثر من خمسة قرون. واستيعاب هذه الحقيقة العلمية يتطلب عقلا علميا وليس العقل الأدبي للأستاذ عصيد.
ثالثا: اخترت النموذج الثالث من آخر ما توصل إليه العقل البشري وأقصد الروبوتات التي تستعمل الذكاء الاصطناعي. العقل الأدبي للأستاذ عصيد ربما لا يعرف أن الروبوت يقوم على أساس حقيقتين علميتين: الالتقائية أو الأتمتة والذكاء الاصطناعي. هذه الحقائق تجعل من روبوت أبو العز الجزري في القرن 12 ميلادي، أول روبوت يلهم العالم الحديث.
وانتظرت البشرية سنة 1954 ليقوم المخترع الأمريكي -جورج ديفول- بتطوير فكرة الجزري ويصنع ثاني روبوت في تاريخ البشرية ويسميه “أنيميت” باستعمال تقنيات القرن العشرين الذي شهد اختراع الترانزستور وتطور علوم الإلكترونيك والإعلاميات. ولذلك يُصف بعض المتخصصين في تاريخ العلوم، الجزري بأنه “أبو الإنسان الآلي” وديفول “أول مخترع للروبوت”. لكن في نظر آخرين يظل الجزري أول من اخترع الروبوت في العالم.
أكتفي بهذا القدر دون التفصيل في ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية التي أحدثت ثورة في العلوم الطبية، والغرفة المظلمة لابن الهيثم مخرع علوم البصريات وتقنيات التصوير، ودور ابن سيناء في تطوير آليات تشخيص المرض الذي يعتمد عليه الطب في وقتنا الحاضر…
علما أن كل هؤلاء الأعلام الذين ساهموا في تطوير العلوم، درسوا في صباهم علوم القرآن والسيرة النبوية، وحتى العلوم الشرعية كما هو شأن الزهراوي الذي كان مولعا بالعِلم فدرَس الشريعة والفقه، واختار علم الطب لخدمة أهل مدينته الفقراء ولُقِّب بطبيب الفقراء، حتى قيل فيه إنه كان من أهل الفضل والدين والعلم لأنه كان يخصص نصف نهاره لمعالجة المرضى مجانا.
هذه الحقائق يعرفها جيدا العقل الأدبي لعصيد، لكنه لا يريد الإفصاح عن ذلك في شريطه الذي تناول فيه علوما دقيقة بعيدة عن طبيعة ثقافته.
فهل نتَّبع العقل التنويري الذي يقوم على أساس التخصص، وهو من مقومات تقدم أوروبا في العلوم والاختراعات؟ أم نكتفي بالعقل التنويري لبعض المثقفين في بلدنا، الذين يفهمون في كل شيء، كما هو شأن الدكتور الفايد، لنسير في الاتجاه المعاكس للتقدم الذي أحرزه الغرب. والنتيجة لن تخرج علميا وعقليا عن مجتمع لا هو حافَظَ على درجة تقدمه النسبي، ولا هو التحق بتقدم العالم الغربي.
إنه التنوير بلغة بعض المثقفين الذين يحملون عقلا أدبيا، لكنهم يفهمون في العلوم الدقيقة أكثر من العقل العلمي الخالص حسب تعبير كانط.
إنه التنوير بلغة عصيد وثقافة الفايد. فإلى أين نسير بهذا التنوير؟
سعيد الغماز-كاتب وباحث



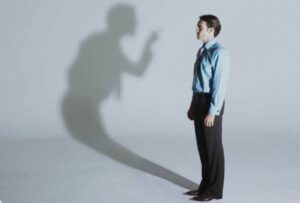

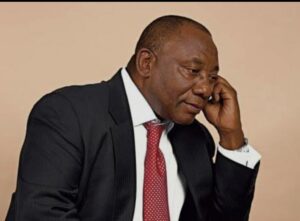

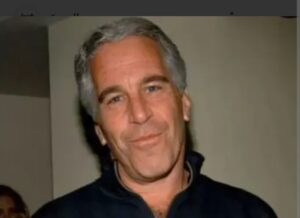
التعاليق (1)
أولا أي تحليل مبني على مرجعيات دينية فهو شارد و غير عقلاني بالمفهوم الصحيح
ثانيا إن نبشك للروبوتات و العلوم الحقة يستوجب معرفة عميقة للأمور و ليس إنشاء أدبيا بسيطا لذا يجب الابتعاد عن الغوص في أشياء قد يجهلها حتى ذو الاختصاص
ثالثا اللغة ليست معيارا يضفي نكهة الانتصار على موضوع تصعب مقاربته بالإديولوجيات سواء الطلابية أو العصيدة هذه الحداثة فهي واقع معاش في العالم c est une realité comme IA BiG data …….الحديث عن العصور الوسطى ولى و لا رجوع للوراء